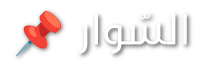لطالما شكّلت الغيبوبة حالة طبية معقّدة حيّرت الأطباء والمجتمعات على مر العصور، لا سيما في الفترات التي لم يكن فيها العلم قد بلغ مرحلةً كافيةً من التطور لتمييز الغيبوبة عن الوفاة. فحالة الغيبوبة، أو “الكوما”، هي غياب تام للوعي، حيث يفقد المصاب القدرة على الاستيقاظ أو الاستجابة لأي مؤثرات خارجية مثل الألم أو الضوء أو الصوت، مما يجعلها شبيهة بالنوم العميق، ولكن دون أي تفاعل مع البيئة المحيطة، حتى أن بؤبؤ العين لا يستجيب للضوء، والتنفس يصبح غير منتظم.
لذلك، ونتيجةً لقصور المعرفة الطبية في العصور السابقة، كان المصاب بالغيبوبة يُشخّص في كثير من الأحيان على أنه متوفى. فحتى القرن الثامن عشر، كان يُفترض أن من يدخل في غيبوبة قد مات، نظراً لعدم وجود أدوات دقيقة قادرة على إثبات العكس. وقد ترتب على هذا التصوّر الخاطئ وقوع حوادث مروّعة، حيث دُفن بعض الأشخاص أحياء نتيجة هذا الالتباس الطبي.
من بين القصص التي تجسّد هذه المأساة، حادثة وقعت في صيف عام 1915 في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، حيث أُصيبت امرأة تُدعى “إيزي دومبر” بنوبة صرع حادة أفقدتها الحركة تمامًا. وعندما حضر الطبيب لفحصها، لم يجد أي علامات تشير إلى حياتها، فأعلن وفاتها. جُهز التابوت وأُقرّ أن الجنازة ستكون في اليوم التالي، انتظارًا لوصول شقيقتها من مدينة بعيدة. غير أن الشقيقة وصلت متأخرة، في اللحظة التي كانوا يهمّون فيها بإنزال التابوت إلى القبر. وبإلحاح منها، طُلب فتح التابوت لتلقي نظرة الوداع الأخيرة، وهنا حدثت المفاجأة: إذ كانت “إيزي” جالسة داخل التابوت تنظر إلى الحاضرين باستغراب! عمّت المكان حالة من الهلع، إذ ظنّ البعض أنهم أمام شبح، لكن الحقيقة كانت أن “إيزي” لم تكن ميتة، بل في غيبوبة مؤقتة، وقد نجت منها وعاشت بعد تلك الحادثة 47 عامًا، إلى أن توفيت أخيرًا عام 1962.
ليست هذه الحادثة فريدة من نوعها، فقد تكررت بشكل لافت، خصوصًا في القرن التاسع عشر، حين بدأت تقارير عديدة تتحدث عن دفن أحياء بسبب تشخيصات خاطئة. ففي عام 1822، تعرّض رجل ألماني في الأربعين من عمره، يعمل بصناعة الأحذية، لحالة غيبوبة مفاجئة. وبما أن الناس آنذاك لم يكونوا يدركون طبيعة الغيبوبة، تم دفنه مباشرة. ولكن بعد انتهاء مراسم الدفن، سمع عامل المقبرة صوت طرق من داخل القبر. وعندما أعاد فتحه، اكتشف أن الرجل ما زال على قيد الحياة! فتم نقله إلى الطبيب على الفور لمحاولة إنقاذه، لكن رغم الجهود المبذولة لإنعاشه على مدى ثلاثة أيام، فشلت المحاولات وتوفي أخيرًا، ليُدفن للمرة الثانية.
أما في فرنسا، وتحديدًا في عام 1867، فقد وقعت حادثة مشابهة لامرأة في الرابعة والعشرين من عمرها، دُفنت عن طريق الخطأ قبل أن يُكتشف لاحقًا أنها كانت حية. وعلى الرغم من إخراجها من التابوت، إلا أنها توفيت في اليوم التالي.
كل هذه القصص أثارت رعبًا شديدًا في أرجاء أوروبا، وأثارت مخاوف واسعة من التعرض للدفن أحياء. وكنتيجة لذلك، بدأت مجتمعات العصر الفيكتوري بتنظيم جمعيات ومؤسسات هدفها مكافحة الدفن الخاطئ. وقد تمخض عن هذا الخوف حلولٌ غريبة، أُريد منها التأكد من موت الشخص فعليًا.
فعلى سبيل المثال، كان من الطرق الشائعة استخدام شفرات حادة لجرح قدم “الميت”، على أمل أن يتسبب الألم في إفاقته إذا كان في غيبوبة. وإذا لم يظهر أي استجابة، كان يُفترض أنه قد مات. كما استخدموا طريقة تعريض إصبعه للحرارة الشديدة، أو حتى إفراغ معدته ظنًا منهم أن الجوع الشديد قد يدفعه للاستيقاظ.
غير أن كل تلك الطرق أثبتت فشلها، إذ أن المريض بالغيبوبة، خاصة إذا كانت غيبوبة عميقة، لا يتفاعل مع الألم أو الحرارة أو غيرها من المحفزات الخارجية. وبالرغم من ذلك، ظل الهوس بالدفن الخاطئ يزداد، مما أدى إلى ابتكار وسائل وقائية جديدة، وإن كانت لا تقل غرابة عن سابقاتها.
من أبرز هذه الابتكارات، كانت التوابيت “الآمنة”، والتي صُممت بفتحات تهوية وبداخلها حبل موصول بجرس خارج المقبرة. فإذا ما كان الشخص ما زال حيًا وشدّ الحبل، يُقرع الجرس، فيدرك حارس المقبرة الأمر ويُسارع إلى إنقاذه. كما صُمّمت أنواع أخرى من التوابيت تحتوي على أنظمة ميكانيكية تسمح بفتح الغطاء تلقائيًا في حال صدرت أي حركة من الداخل.
ورغم أن تلك الحلول لم تكن فعّالة دائمًا، إلا أنها كشفت عن مدى القلق المجتمعي من فكرة الدفن أحياء. بل إن انتشار قصص قرع الأجراس ليلًا أدى إلى حالة من الذعر، خاصة عند سماع الجرس بسبب الرياح، مما ساهم في ترسيخ بعض الأساطير مثل أسطورة مصاصي الدماء، الذين يُقال إنهم يخرجون من القبور ليلًا ويندثرون مع أول ضوء للنهار.
ومع مرور الوقت، بدأ الأطباء يعتمدون على طرق أكثر عقلانية لكشف حالة الوعي، مثل تمرير فرشاة خشنة على الجلد أو وضع أعشاب مهيّجة ومراقبة تغيّر لون الجلد، والذي قد يدل على استمرار الدورة الدموية، وبالتالي حياة الشخص. بل ووُجدت أدوات أكثر دقة مثل “مقياس الموت”، وهي إبرة معدنية تُغرس في الجسد، ثم تُقاس درجة حرارتها بعد دقائق لمعرفة حرارة الأعضاء الداخلية، حيث تكون مرتفعة لدى الأحياء.
ومع التقدّم الطبي الحديث، لم يعد من الصعب التمييز بين الوفاة والغيبوبة، بفضل تقنيات التصوير العصبي وأجهزة مراقبة القلب والدماغ، بالإضافة إلى الخبرة المتقدمة لدى الأطباء في التمييز بين الحالتين.
في الختام، تكشف لنا هذه القصص أن تطور الطب لم يكن مجرد رفاهية، بل كان مسألة حياة أو موت. كما تؤكد أن الجهل بالعلم قد يؤدي إلى مآسٍ حقيقية، كان من الممكن تفاديها ببساطة لو توفر الحد الأدنى من الفهم الطبي.
هل كنت لتخطر ببالك وسيلة مبتكرة في ذلك الزمن لتفادي دفن الأحياء؟